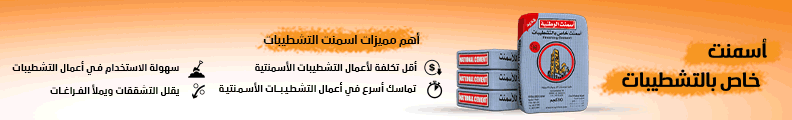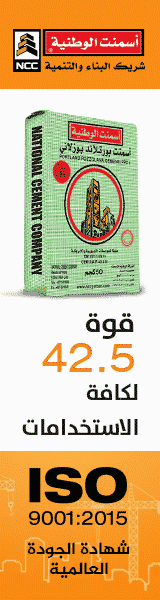على الرغم من أن دول «منظمة المؤتمر الإسلامي» تمتاز بتنوّع الأوضاع الاقتصادية فيها، نظراً لتمتع بعضها بعدد من الثروات الطبيعية والباطنية، والعوامل المساهمة في امتلاك اقتصاد متين ومتطوّر، إلا أنها تعاني من ضعف الإمكانيات الاقتصادية، وانخفاض مستويات المعيشة، وانتشار الفقر بين أبنائها، وضعف الأمن الغذائي.. وهذا التنوّع والاختلاف في الوضع الاقتصادي من المفترض أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق نوع من التوازن بين دول المنظمة، يمكن تحقيقه بالتعاون بين هذه الدول، بحيث توفّر بعضها فرص عمل جيّدة بينما توفّر الأخرى أسواقاً لتصريف المنتجات وبيئات استثمارية رائدة، وتصدّر غيرها العمالة الرخيصة أو الكوادر المؤهّلة.
هذه المسألة يناقشها الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص الذي تستضيفه إمارة الشارقة في الأسبوع القادم، وتشرف على تنظيمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وفي هذا الإطار أشار سعادة حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أهمية التعاون والتكافل بين مختلف الدول الإسلامية وقال:
«» إنّ ما يميّز العلاقة بين الدول الإسلامية أنّها تأخذ بالحسبان أعراف التكافل الاجتماعي الذي يحثّ على تقديم المساعدة وتحقيق التوازن الاجتماعي، بغض النظر عن النفع المادي من وراء ذلك، فنحن لسنا مجتمعاً براغماتياً، وإنّما أورثتنا 1400 سنة من القيم الإسلامية مجتمعاً تكافلياً تعاونياً، يعتمد فيه الفرد على المجموع، والمجموع على الفرد، وهذا المجتمع الذي يعتمد على مبدأ (الجسد الواحد) يستطيع أن يبني اقتصاداً تنافسياً قويّاً، بفضل تماسكه، ومن هذا المنطلق تستطيع الدول الإسلامية التي تمتلك اقتصاداً متيناً وإمكانيات قوية أن تبادر إلى مساعدة شقيقاتها من الدول الأقلّ حظّاً، وذلك عبر التسهيلات القانونية والإجرائية، على حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الإسلامية، ووضع قوانين خاصة بالديون والقروض تصبّ في مصلحة الطرفين (الدائن والمدين).. وبالتالي سيسهم كل ذلك في تفعيل حركة التبادل التجاري بين هذه الدول، وسيكون له الدور الأبرز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها.
وفي الواقع يواجه قطاع الأعمال في الدول الإسلامية كثيراً من التحديات التي تحتاج إلى دراسات متأنية وحلول استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتمتين الاقتصاد في المستقبل، وقد خطت بعض هذه الدول خطوات مهمة في هذا المجال بالانطلاق نحو اقتصاد المعرفة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقات البديلة والمتجددة لتحقيق تنمية اقتصادية تقود إلى التنمية الشاملة وتطوير المجتمع.
ويوماً بعد يوم، تمكنت المصارف الإسلامية من اختراق أسوار النشاط المصرفي التقليدي، واستطاعت بآلياتها وأدواتها التمويلية المستحدثة وعلى رأسها إقرار مبدأ التمويل بالمشاركة في الربح أو الخسارة، أن تُدخل في دائرة هذا النشاط فئات من المدخرين وأصحاب المشروعات لم يكن لها نصيب فيه قبل ذلك، وكذلك أتاحت تمويلاً لم يكن متاحاً من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وتقدر قيمة التمويل الإسلامي عالمياً بتريليون دولار، ومشكلة السوق المصرفية الإسلامية تكمن في عدم امتلاك المؤسسات المالية الإسلامية الأدوات التي تمكنها من استثمار السيولة الضخمة التي تمتلكها هذه المؤسسات، أما ما يميزها فهي المعايير والصفات الإسلامية الخاصة بها، كونها تتمتع بمزيج من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية. ومن هذه المصارف الإسلامية:
البنك الإسلامي للتنمية
«أنشئ » البنك الإسلامي للتنمية « عام 1973، ومقره الرئيس في مدينة جدة السعودية، وهو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تملكها وتديرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وللبنك تعبئة الموارد المالية بالوسائل التي توافق أحكام الشريعة الإسلامية، ويساعد في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء، وتشجيع التنمية الاقتصادية، كما يعزز التبـادل التجاري بينها، ويقدم لها المساعدة الفنية، وتوفير التدريب للموظفين الذين يتولون أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية، ويشترط للحصول على عضوية البنك أن تكون الدولة عضواً في » منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقاً لما يقرره مجلس المحافظين.
مصرف الشارقة الإسلامي
«اكتسب » مصرف الشارقة الإسلامي السمعة الطيبة منذ إنشائه عام 1975، من خلال توفير أعلى مستويات الخدمة، وشهد أيضاً مراحل نموٍ غير مسبوقة زادت من قوته وثباته. ولقد نجح المصرف في إيجاد مجموعة متنوعة من المنتجا
|
البنية التعليمية الضخمة القائمة على أسس قديمة في البلدان الإسلامية لم يعد بإمكانها مقاومة ضغوط متطلبات العصر |
ويتبع المصرف نهجاً مسؤولاً، ويأخذ كل مبادرة للاضطلاع بدوره الاجتماعي والاقتصادي في تطوير المجتمع، كذلك يعمل المصرف جاهداً على جعل أنظمته الداخلية ومنتجاته وخدماته المصرفية تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والمالية، في إطار من القيم الأخلاقية والاجتماعية والمعتقدات الدينية، وذلك كله لتلبية احتياجات ومتطلبات شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.
مجموعة دلة البركة
«انطلقت » دلة البركة من مكتب صغير بمدينة الرياض سنة 1969م، حين أسسها الشيخ صالح كامل، وتوسعت على مدى الأربعين عاماً الماضية، لتصبح إحدى أكبر مجموعات الأعمال في العالم حيث توجد في أكثر من 40 دولة، وتدير استثمارات ضخمة في مجالات التجارة والعقار والخدمات المالية والرعاية الصحية والتشغيل والخدمات والصيانة والنقل والمواصلات، وبالإضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل لها، تمتلك المجموعة حصصاً رئيسة في شركات استثمارية محلية وعالمية بغرض توثيق الروابط وتحقيق المصلحة المشتركة.
«وتفخر » دلة البركة اليوم بأنها تضم أكثر من 60,000 موظف حول العالم، وتغطي استثماراتها نطاقاً واسعاً من الأعمال في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع التركيز على تنمية المجتمعات المسلمة حيثما كانت، وعلى مدى العشر سنوات الماضية احتلت المجموعة المرتبة الخامسة ضمن أكبر 100 شركة سعودية، هذا وتحرص مجموعة دلة البركة في عملها على تطوير الأفراد والمجتمعات، بما يحقق الفائدة لأفراد ذلك المجتمع ويساعد على تطوير أسلوب الحياة للمجتمع ككل، وتعمل على إيجاد استثمارات ذات جودة عالية، واستكشاف فرص العمل المجدية، وتوسيع مجالات الأعمال، وزيادة الدخل لجميع الأطراف بما ينسجم مع المبادئ الإسلامية.
الأمن الغذائي الإسلامي
«حتى تستطيع الدول الإسلامية التحول إلى » اقتصاد المعرفة عليها أن تواجه التحديات المختلفة المترتبة لتقليص الفجوة المعرفية
تعاني بلدان العالم الإسلامي من مشكلة غذائية متمثلة في عجز الإنتاج المحلي عن توفير الاحتياجات الاستهلاكية لسكانها، وأخرى متمثلة في معاناة أغلب الدول الإسلامية من انعدام الأمن الغذائي، حيث لا تستطيع تلك الدول توفير الغذاء للسكان من خارج حدودها، إما لضعف مقدراتها الاقتصادية، أو بسبب التغيرات المناخية التي شهدها كوكب الأرض مؤخراً.
ولا تتوقف المخاطر المستقبلية عند هذا الحد، بل إن محاولة فرض ضغوط سياسية واقتصادية على الدول الإسلامية بحجة مكافحة الإرهاب، كل تلك المخاطر وغيرها تستلزم بلا شك أن تسعى الدول الإسلامية إلى اتخاذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي لسكانها وتقليل الاعتماد على الخارج.
التعليم واقتصاد المعرفة
تتوقف التنمية الاقتصادية لأي بلد على قاعدته العلمية والتكنولوجية واستغلالها في القطاعات الرئيسَة، ولا مفرّ من الإقرار بأن البلدان الإسلامية تعدّ في مصاف الدول البطيئة النمو، وهذه الوضعية كانت مبعث قلق شديد بالنسبة للبلدان الإسلامية التي أخذت في السنين الأخيرة تدرك خطورة الموقف. فتحقيق الرخاء المنشود يقتضي توفر عنصرين أساسَيْن وهما الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية، والاستثمارات في مجال البحث والتنمية، وهي أمور يفتقر إليها العالم الإسلامي برمته، الذي لا يتجاوز عدد المتعلمين من سكانه في المتوسط 55 %، ويقدر مجموع الأطر العلمية والتكنولوجية في البلدان الإسلامية حالياً بحوالي 7,6 مليون، وهي نسبة لا تتعدى 3,7 % من مجمل الكفاءات العلمية والتكنولوجية في العالم. وهذا دليل على أن هناك نقصاً في الأطر العلمية والتكنولوجية، وفي الأطر المؤهلة العاملة في مجال البحث في خدمة التنمية بشكل خاص.
ولا جدال أن التعليم العلمي هو الذي يساهم في تحقيق النمو والتنمية في بلد ما. ومن ثم، فلا يمكن التقدم بخطا حثيثة في مجال الاقتصاد ما لم تُولَ عناية فائقة للتعليم العلمي والتكنولوجي على المستويات التعليمية كافة في البلد. ولقد قامت البلدان الإسلامية فيما سبق بمحاولات جادة لإصلاح النظام التعليمي، غير أن البنية الضخمة القائمة على أسس قديمة لم يكن بإمكانها مقاومة ضغوط متطلبات العصر.
وحتى تستطيع الدول الإسلامية التحول إلى اقتصاد المعرفة، وتستفيد من نتائجه المؤدية إلى التطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، عليها أن تواجه التحديات المختلفة المترتبة عليه لتقليص الفجوة المعرفية، وأن تكون لها استراتيجيات لحفز الاقتصاد المعرفي.
مفتاح الحل
تكتسب الطاقة المتجددة أهمية خاصة مع تزايد الطلب عليها، وذلك لأنها لا تنضب ولا تتأثر بالظروف الدولية والطبيعية، ولأنها طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، ونشر هذه الطاقة واجب الجميع ومسؤولية حضارية. والعبور إلى أفق هذه الطاقة واستعادتها أصبح ضرورة أكثر مما هو تقليد، فالطاقة المتجددة بأنواعها، ستوفر فرص عمل متعددة للشباب، وتتيح المجال للاستثمار في مجالات حيوية.
وانطلاقاً من هذه الأهمية يجب توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة في البلدان الإسلامية، وتشجيع البحث العلمي، وتنمية روح الإبداع والابتكار، والتأسيس لإجراء الأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة.
وعلى هيئات البحث العلمي في تلك البلدان أن تؤدي دورها في تطوير استثمار تقنيات الطاقات المتجددة، بأن تساهم في ربط المؤسسات البحثية، وتوجيه الكفاءات، وخلق وسائل التمويل والشراكة.
أخيراً، لم يعد أمام الدول الإسلامية بعد كل تلك الدلائل سوى زيادة أوجه التعاون بينها، وتشجيع إقامة المشروعات الزراعية المشتركة، وإزالة القيود والعقبات الجمركية على التجارة الخارجية للدول الإسلامية، خاصة أنها بصفة عامة تمتلك من المقومات والموارد ما تستطيع به تحقيق التعاون والتكامل بينها، عاجلاً وليس آجلاً.